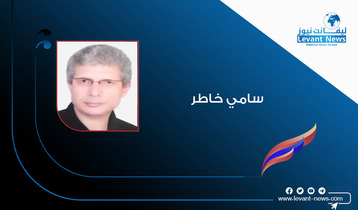-
الجولاني من القاعدة الى الحكم

من قلب مفارقة عالم يرفع شعارات “القيم” ويحكم بمنطق “المصلحة”، قُدِّم للسوريين نموذج فريد: تحويل زعيم خرج من بنية القاعدة إلى رأس سلطةٍ تُطلّ بوجهٍ مدني وتعمل بجهازٍ عقائدي قديم. هذا الانتقال لم يولد من مراجعة فكرية أو عقدٍ اجتماعي، بل من هندسةٍ باردة سمحت لـ“العدو الوجودي” أن يصبح شريكاً وظيفياً، ما دام يضبط الخراب ويُطمئن الخارج.
هكذا انقلبت سردية “الحرب على الإرهاب” إلى سردية “إدارة الإرهاب”، وتحوّل التطرّف المُعاد تدويره إلى منتجٍ سياسي قابل للتسويق الدولي.
لم تكن أفغانستان ظلاً بعيداً، بل “دفتر شروط” مفتوح. منذ لحظة تسلّم طالبان كابول، تدرّج الاعتراض الدولي من الإدانات اللفظية إلى قنوات الاتصال فالاعتياد؛ عندها استوعبت جماعات أخرى الدرس: لا حاجة لتغيير البنية، يكفي تلطيف الخطاب وارتداء قناع الدولة بانتظار القبول التدريجي.
في سوريا، قُلّدت التجربة حرفياً: خطابٌ عن “الاستقرار ومكافحة الفوضى”، إعلانٌ دستوري صوري، وتقديم القائد كـ“رجل مرحلة” يحمي من طوارئ إيران ومن شبح داعش، ببيئة سورية أشد هشاشة وتعقيداً من أفغانستان وأفقر بقاعدةٍ اجتماعية مفككة.
على الأرض، بُنيت السلطة بآليات الغلبة لا بآليات التوافق: فراغ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 ملأته قبضةٌ أمنية لحظية أعقبتها صياغة إعلان مؤقت في دمشق عبر لجنة شكّلها رأس السلطة نفسه؛ لم يكن ذلك تأسيساً لشرعيةٍ، بل تشريعاً لاحقاً لواقعٍ فُرض بالسلاح ثم أُلبِس لغة القانون. من هنا انطلقت دولةٌ هجينة: مؤسسات بواجهات مدنية وقلوبٍ أمنية، مجالس وتعيينات وانتخابات محدودة تُبقي القرار في مركزٍ واحد، وقضاءٌ مُعاد تغليفه يداوم على منطق الضبط والولاء.
وخارج الأرض، تكفّل “التبييض الناعم” بالباقي. بدأت القصة بصورة: مقابلات مُحكمة الإخراج، قاموسٌ عن “الدستور والانتخابات”، ومواد مرئية تُبرز الخدمات والأسواق وتُسقط منهجياً سجلات الاعتقال والتغييب. تحوّل القائد إلى “حاكمٍ فعلي” و“نقطةٍ مضيئة”، واكتملت الدائرة حين تبنّت مراكز فكرٍ غربية مفردات “الواقعية والبراغماتية”، فصار السؤال: كيف نتعامل معه؟ لا: من هو؟ ولماذا يحكم؟ بذلك انتقل الإعلام من توصيف الواقع إلى صنع سرديته، ووفّر الجسر النفسي لمقاربةٍ سياسية تُسوِّغ الاعتراف الوظيفي.
التحوّل الأمريكي كان لحظة مفصلية: مسارٌ تواصلي منذ 2019، ليونة لغوية ثم زيارات غير معلنة بعد ديسمبر 2024، قبل أن تظهر “الرخصة العامة رقم 25” بوصفها تشريعاً اقتصادياً ذا مغزى سياسي: تمكين التعامل مع حكومة الأمر الواقع وكياناتها، كإشارة قبولٍ مُضمرة بأن “التحوّل الشكلي” يكفي لإعادة الإدراج في السوقين المالي والسياسي. هذه ليست رخصة معاملات فحسب؛ إنها هندسة اعترافٍ مشروط تعيد تعريف العدو حين ينجح في ضبط الفوضى.
الإقليم أكمل المعادلة: ضغطٌ خليجي لدفع مسار “GL 25” وتوسيع التمويل المشروط، رهانٌ تركي على ترويض “نسخة مخففة” عبر أدوات الدولة والاقتصاد الحدودي، وبرودٌ روسي براغماتي يساير الأمر الواقع طلباً لتقليل الخسائر، فيما تُفضل طهران “لا عداء” محسوباً وتقاطعاتٍ وظيفية تمنع التصادم وتُبقي خطوط المصالح مفتوحة.
كل طرفٍ وجد في السلطة الجديدة شيئاً يُسكن هواجسه: حاجزاً ضد إيران، أو ضد داعش، أو ضد الانهيار، أو ضد الفراغ—لكن أحداً لم يسأل: بأي كلفة مؤسسية وأخلاقية؟ وأي مستقبل لنموذجٍ تلبس فيه القوةُ قناعَ القانون؟
النتيجة البنيوية واضحة لمن يقرأ تحت السطح: شرعيةٌ تُنتَج من القدرة على “ضبط الأمن” لا من العقد الاجتماعي، مؤسساتٌ تؤدي وظيفة التبعية لا وظيفة الموازنة، أمنٌ عام هو قلب النظام لا سياجه، واقتصادٌ ريعيّ يُعيد تدوير الجباية والمعابر بوصفها أدوات سلطة.
هنا تتضاعف الأخطار: داخلياً، هشاشةٌ اجتماعية ورفضٌ مكتوم في أوساط النخب والبيئات المحافظة على حدٍّ سواء، وتناقضاتٌ داخل المجتمع الجهادي تهدد بالانفجار عند أول تَراخٍ خارجي أو صدمةٍ اقتصادية. إقليمياً، تعميمٌ لسياسة “تدوير الجهادي” بما يعيد إنتاج خطايا أفغانستان والعراق ويصدّر الاحتقان إلى حدود الجوار.
ودولياً، تقويضٌ لمعيارية القانون: إذا كان التصنيف الإرهابي قابلاً للتعديل بقرارٍ سياسي حين تتبدل الوظيفة، فما الذي يبقى من فكرة الردع والعدالة؟
ثمة وهمان كبيران يحرّكان هذا المسار. الأول: وهم الاحتواء. تُظهر التجربة أن تلطيف اللغة لا يبدّل بنيةً عقائدية مُغلقة؛ يمكن ترويض السلوك عند الأطراف، لكن مركز القرار يظل محمولاً على منطق “التمكين” لا منطق الدولة.
والثاني: وهم الاستقرار. إن استقراراً يقوم على استبدال الاستبداد الأمني باستبدادٍ عقائدي أكثر حنكةً وأقلّ قابلية للمساءلة هو استقرار مؤجل؛ كل ما في الأمر أنّ الانفجار ينتقل من الشارع إلى البنية، من العنف الظاهر إلى العنف المؤسّسي. وفي الحالتين، يدفع المجتمع الثمن مرتين: مرّةً حين تُصادَر إرادته باسم الخوف من الفوضى، ومرّةً حين يُعاد تشكيل الفوضى كسياسة دولة.
لهذا يجب تسمية الأشياء بأسمائها: نحن أمام شرعنة “نظامٍ وظيفي” لا “مشروع دولة”. نظامٌ يقيس الشرعية بمدى خدمته لتوازنات الخارج، لا بمدى اتساقه مع حقوق مواطنيه، ويحتكر السياسة بقاموس الأمن ويحتكر الأمن بفقه الطاعة. حين تتواطأ القوى الكبرى على تمرير هذا التعريف الجديد، فإنها لا تُخطِئ بحق السوريين فحسب، بل تضرب شرعيتها هي: إذ تغدو “الحرب على الإرهاب” إدارة لمحاصيله، وتغدو “القيم” أداةَ تسويقٍ لعقودٍ مؤقتة.
ما الذي يخص السوريين في كل ذلك؟ يخصّهم أن هذه اللعبة تُدار بأسمائهم وعلى حساب مستقبلهم. وأن السؤال الحاسم لم يعد: هل نقبل سلطة الأمر الواقع أم نرفضها؟ بل: هل نسمح بتحويل التطرّف إلى دولة، والهوية إلى أداة ضبط، والسيادة إلى امتيازٍ إداريّ تُوزّعه تفاهمات الخارج؟
الإجابة التي تحفظ لسوريا معنى أن يكون بلداً لا “منطقة نفوذ” تبدأ من استعادة معيار الشرعية إلى موضعه: عقدٌ اجتماعي مدني، سيادةُ قانونٍ لا سيادة أجهزة، تداولٌ ومحاسبةٌ لا بيعةٌ مغلَّفة. لا يطالب هذا المعيار بعصا سحرية ولا بيوتوبيا، بل بمسارٍ وطنيٍّ واضحٍ يُخرج السياسة من فائض السلاح ومن عجز الدعاية، ويُعيد تعريف الممكن:
دولةٌ لكل السوريين، لا سلطةٌ على السوريين.
هذه ليست رومانسيةً في مواجهة “واقعية”؛ هذه واقعيةٌ مضادة. واقعيةٌ تعرف أن كل ما لا يُعالج في البنية يعود كارثةً في السلوك، وأن كل اعترافٍ يُمنح بلا معيار سيعود سلاحاً مضاداً للمعيار ذاته. إن كلفة بناء بديلٍ مدنيٍّ سيادي اليوم—مهما بدت مرتفعة—أقل بما لا يُقاس من كلفة العيش طويلاً تحت “أمنٍ” يصادر السياسة و“دينٍ” يصادر الدولة و“وظيفةٍ” تصادر المستقبل.
رسالتي الى السوريين بسيطةٌ وشاقةٌ في آن: لا تتركوا تعريفَ الشرعية يُكتب عنكم وبلاكم. ارفضوا أن يُختزل مصيركم إلى معادلة “إمّا أنا أو الفوضى”. اصنعوا مساركم بأدوات العقد والحقّ لا بأدوات الغلبة والتغليف؛ فكل ما يُبنى على الخوف يُورَث خوفاً، وكل ما يُبنى على الحقّ يُورَث وطناً.
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!